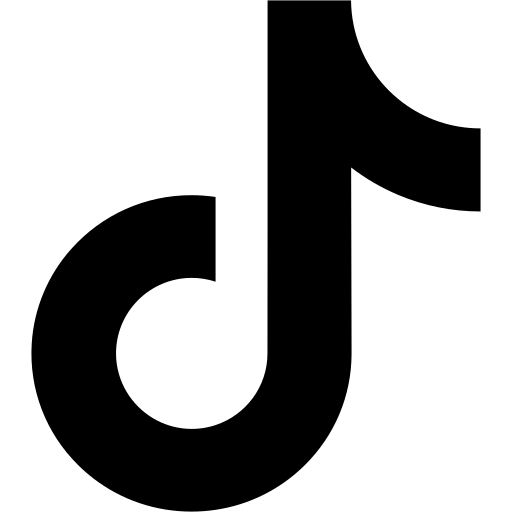الشّاعر والمقهى: عِشرة عُمر!
حين ترتاد المقهى تكون في قلب الحياة ومتفرجاً عليها في الوقت نفسه. وبمرور الأيام، تغدو خبيراً في قراءة الوجوه والنَّاس.
يبدو المقهى بالنسبة إلى البعض مكاناً لتزجية الوقت أو لملء الفراغ، لكنه بالنسبة إلى الشاعر خصوصاً، والكاتب عموماً، أمر مختلف تماماً. يغدو مكاناً موجزاً للحياة برمتها؛ ففي المقهى يلتقي عشاقاً وأصدقاء وزملاء وتجاراً وموظفين وأرباب عمل ومجانين ومهرجين وساسة وجواسيس ولصوصاً وباعة هوى. باختصار، هو مكان لالتقاء أصناف البشر كافة.
طبعاً، ثمة مَن يقصد المقاهي فقط لتزجية الوقت وملء الفراغ، ومنهم مَن يراقب الناس ولا يموت همّاً، ومنهم السعداء والتعساء معاً. وكم تشهد طاولاته ومقاعده على بدايات ونهايات في الوقت ذاته! هنا تولد قصص حب، وهنا تنتهي قصص أخرى. هنا تبدأ صداقات، وهنا تنمو خصومات، كأن ثنائيات الحياة وأضدادها تواطأت على الاجتماع تحت سقف واحد.
كلّ ما يخطر على البال يمكن أن يدور تحت سقف المقهى. هذا السقف الذي يغدو سماءً لحياة كثيرين، لكن علاقة الشاعر بالمقهى تظلّ مختلفة تماماً. بين الشِّعر والمقهى صداقة مزمنة. بين الشعراء والمقاهي علاقة يومية. ليس كلّ الشعراء من رواد المقاهي، لكن الذين يفعلون يقيمون مع المكان علاقة عصيَّة على الفهم والتفسير؛ نوع من الإدمان لا شفاء منه. تغدو الطاولة صديقة، كذلك الكرسي وفنجان القهوة ومنفضة السجائر ومشهد المارة خلف الزجاج. يبدو الخارجُ أشبه بشاشة سينمائية تبثُّ وقائع فيلم طويل لا ينتهي يُدعى: الحياة.
إذاً، ليس كل الشعراء على علاقة وطيدة بالمقهى، لكن مَن يؤمن بأن الشِّعر هو أولاً نمط حياة قبل أن يكون مجرد نظم أو كتابة، يصبح ارتياد المقهى لديه طقساً لا بدّ منه ولا غنى عنه. المقهى يمنح الشّاعر هامشاً من الحرية والتسامح قد لا يوفرهما المنزل أو المكتب. هناك الغرف المقفلة والخصوصيات الحميمة، وهي ليست أقل شأناً، لكنها مختلفة.
هنا (في المقهى) الرحابة والتنوع. لا يختار أحد أحداً من رواد المكان سوى الذي يشاركه الطاولة. البقية وجوه تتغير وتتبدل، وتختلف اختلاف الأهواء والأمزجة. يذهب الشاعر إلى المقهى ذهاباً إلى الحياة أو إلى فصل آخر من فصول الحياة. العلاقات فيه مختلفة جذرياً عن علاقات الأسرة وزمالة العمل ولياقات المجتمع وضروراته… وصداقاته غير صداقات المدرسة والجامعة وسواها من أمكنة الاجتماع الإنساني.
حين ترتاد المقهى تكون في قلب الحياة ومتفرجاً عليها في الوقت نفسه. وبمرور الأيام، تغدو خبيراً في قراءة الوجوه والنَّاس: هذا عاشق على أهبة العناق، تلك فتاة في أول الحُبّ، ذاك متقاعد يستعيد أياماً خلت، وهؤلاء شبان تشتعل رؤوسهم حماسة لا شيباً. أشكالٌ وأنماطٌ من النَّاس والعلاقات يرقبها الشاعر من مقعده بين قصيدة وأخرى أو بين موعد وآخر كأنه في منزلة بين منزلتين؛ شريكٌ في الحياة الدائرة من حوله ومتفرج عليها في الوقت عينه. لذا، نزعم أن نصوص الشعراء من رواد المقاهي أكثر ليونة وطراوة، لأنها أكثر حياة.
نكرر، المقهى بالنسبة إلى البعض مجرد مكان لِتزجية الوقت وتصريف الأيام والأعمار، لكنه للشاعر مختبر تختمر فيه التجربة. أبوابُه لا توصد في وجه أحد. تجاربه على الملأ ونتائجه أيضاً. كم من القصائد كُتبِت فيه! كم من الروايات والمسرحيات والنصوص! وقبل ذلك (كما أسلفنا)، كم من قصص الحُبّ والصداقة والتواصل الإنساني وُلِدَت وانتهت على طاولاته! كم من الضحكات والدمعات وباقات الزهر! كم من الدسائس والخيانات! باختصار: كم من الحياة!
أزعم أنَّني عشت حياة كاملة ومتعددة في مقاهي بيروت. حياتي في المقهى ألهمتني كتاباً كاملاً سمّيته “قهوة سادة/ في أحوال المقهى البيروتي”، حاولت من خلاله مقاربة الدور الثقافي/الاجتماعي، والسياسي أحياناً، الذي يؤدّيه المقهى في حياة النَّاس وشرح المتغيرات التي أصابته منذ نشوئه في إسطنبول عام 1554 على يد السّوريين حكم الحلبي وشمس الدمشقي، واستطلعت عينة من رواده الذين شكّل المقهى بالنسبة إليهم مختبراً ومنبراً لآراء وأفكار ومؤلفات كثيرة.
ولا غرابة إذ كان لكل مقهى دور ورواد؛ هذا للشعراء، ذاك للعشاق. هنا ملتقى الساسة، وهناك ملتقى الجواسيس. نعم، الجواسيس. أحد مقاهي بيروت كان معروفاً قبل الحرب الأهلية بأنه وكر جواسيس! مثلما يمكن للمقهى أن يتحوّل إلى رمز لحدث كبير، كما حصل مع مقهى الويمبي (الذي أُقفل للأسف)، حين أفرغ الشهيد خالد علوان رصاص مقاومته في صدور جنود الاحتلال الإسرائيلي مطلع خريف العام 1982.
كل مَن يرتاد، بشكل دائم، مقاهي شارع الحمرا (مثلاً) التي عرفت أزمنة عزّ وأوجاً ذهبياً، مثلما عرفت أزمنة خفوت وشحوب، يدرك حجم المتغيرات التي أصابت الشارع والمدينة من خلال تغير المقهى نفسه واختلاف رواده وتبدّل دوره؛ فالمقاهي مرآة المدينة، تتوهج بتوهجها، وتخفت بخفوتها، وتزدهر بازدهارها، وتشحب بشحوبها.
تدور الأيام وتتغير الأحوال، ويظلّ لقراءة الشِّعر أو للندوات الفكرية والأمسيات الموسيقية هنا، في مقاهي بيروت، وفي هذه اللحظات الحرجة من تاريخ لبنان، وفي زمن الخراب العظيم، مذاق خاص، إذ تصير الكلمة برهانَ حياة، ويصير التحلّق حول قصيدة بمنزلة انحياز إلى إرادة الحياة المنتصرة لا محال على الموت.
هنا نفهم أكثر قول محمود درويش الذي تحلو لي العودة إليه دائماً: “هَزَمَتْكَ يا موتُ الفنونُ جميعُها، هَزَمَتك يا موتُ الأغاني في بلادِ الرافدينِ، مسلَّةُ المصري، مقبرةُ الفراعنةِ، النقوشُ على حجارةِ معبدٍ هَزَمَتك وانتصَرتْ، وأفـْلتَ من كمائِنِكَ الخلودُ، فاصنعْ بنا، واصنع بنفسِك ما تُريدُ…”، فالفن، وفي مقدمته الشِّعر، انتصار لإنسانية الإنسان والفارق الأجمل بينه وبين بقية الكائنات. يمضي الساسة وتنساهم الأيام، ويظل الشعراء والأدباء في ذاكرة الزمان.
التغيير سنّة الحياة. تتغير حال المقهى تَغَيُّرَ أحوال الدنيا. ولئن كان زمن النرجيلة الأجوف قد فرض طقوسه على كثير من الأمكنة وناسها، تبقى فسحاتٌ تقارع وتكافح لأجل أن يبقى للمكان روحه ومعناه، ومنها تلك المقاهي التي تُوَسِّع مساحاتها بالقصائد ويتحلَّق روادها حول نار الشِّعر التي لن تنطفئ مهما عصفت ريحٌ وادلهمَّ أفقٌ، وبدا أن الكلمة الولّادة في وحدةٍ موحِشة، فالكلمة لم ولن تموت، لأنها إذا فعلت مات الإنسان!
في البدء كان الكلمة… وإلى دهر الداهرين.